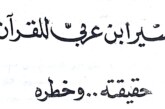بين إيمان العقل وإيمان القلب
أبو الحسن الأشعري
الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة
لما ظهر أمر الإسلام وامتدت أشعة نوره إلى أطراف جزيرة العرب انبعثت نفس فتى بمنى إلى الهجرة نحو الشمال ، نحو منبع ذلك النور ؛ فاستصحب أخوين له وخرج في أكثر من خمسين رجلا من قومه مهاجراً ، تشرئب روحه نحو طلب الحق؛ وعرّج هؤلاء المهاجرين على الحبشة فأقاموا حينا في كنف النجاشي مع بعض مهاجري المسلمين، ثم تحركوا قاصدين المدينة؛ وكان يقودهم أبو موسى الأشعري، وهو ذلك الفتى اليمني الذي صار صحابياً معروفاً .
وإن النبي عليه السلام لجالس يوما في المدينة إذ قال: « الله أكبر ! قد جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن».
قيل: وما أهل اليمن؟ قال: « قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم؛ الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية».
ولما وفد القوم على النبي قال لهم : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ! » ، فلم يتبادر إلى أذهانهم بشرى بعطاء أو نحوه كغيرهم ، بل قالوا : « قبلنا يا رسول الله ، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر : ما كان ؟ » فقال لهم : « كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض ، وكتب في الذكر لك شيء » ، ويستدل العلماء من ذلك كله على سمو نفس الأشعريين اليمنيين وعلى نبل مقصدهم من هجرتهم ؛ ولا غرو فإن بلاد اليمن مهد لحضارة روحية وفنية واجتماعية قديمة ، كما تدل على ذلك آثارهم التي ترجع إلى ما قبل الإسلام بأكثر من ألف عام .
واستقر أبو موسى وقومه في المدينة مقبلين على الدين بكل ما في قلوبهم من سلامة وما في طبعهم من رقة التهذيب؛ وكان أبو موسى نفسه يتميز بحسن الصوت، حتى لم يكن مزمار ولا صنج أحسن من صوته، وحتى كان المصلون وراءه يودون لو أطال في صلاته حتى يأتي على آخر أطول السور. وكان الأشعريون في المدينة تُصْرَف منازلهم من أصواتهم القرآن في الليل ، كانوا في حياتهم مثالا للبر والتعاون، فكانوا إذا أرسلوا في الغزو وقل طعام عيالهم في المدينة ، جمعوا كل ما عندهم ثم اقتسموا بالسويّة، ولذلك كان النبي يقول فيهم: « هم مني وأنا منهم » ؛ ويحكى المؤرخون أنه لما نزلت آية : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ أشار النبي إلى أبي موسى وقال : « هم قوم هذا » .
وقد أثبت هؤلاء الأشعريون أنهم أهل لثقة النبي ولما تذكره الآية الكريمة، فقد جاهدوا في سبيل الله، واشترك أبو موسى وقومه في محاربة المرتدِّ بن أيام أبي بكر كما فتح أبو موسى، وكان والياً على البصرة في عهد عمرو وعثمان، للإسلام أرضا كثيرة من بلاد العجم؛ وولى بعضً أبنائه القضاء، ولم يزل منهم بالبصرة من كان يذكر بالرياسة حتى عهد أبي الحسن الأشعري في البطن التاسع من ولد أبي موسى .
من هذه الشجرة اليمانية الطيبة انحدر أبو الحسن يحمل في عروقه رقة أهل اليمن وفي قلبه عمق إيمانهم إلى ما انصاف إليه من تأثير الإسلام ؛ وقد ورث عن جده إلى جانب الملكة الفنية رأيه الأساسي في الرضا بالقدر ؛ فقد روى أن مناظرة جرت بين عمرو بن العاص وبين أبي موسى الأشعري . قال عمرو : إن أجدُ أحداً أُخاصم إليه ربي ! فقال أبو موسى : أنا ذلك المُتَحاكم إليه ، فقال عمرو : أيقدِّر على شيئاً ثم يعذبني عليه!؟ قال أبو موسى: نعم ؛ فقال عمرو : ولِمَ ؟ قال أبو موسى : لأنه لا يظلمك ؛ فسكت عمرو ، ولم يُحرّ جواباً .
ولد أبو الحسن في بيت الأشعري تتغذى روحه من التقوى المعروفة فيهم ومن النزعة السلفية من إقبال على الحديث والعمل بالسنة والوقوف عندها ؛ فكانت تربيته الأولى في كنف أبيه سُنِّية جادة ، أساسها العمل والتقوى لا الكلام ؛ ولكن شاء القدر أن ينقطع انصال هذه التربية ، لأن والد أبي الحسن اختُرم ، وهو ما يزال صغيرا ؛ فتزوج من أمه أكبرُ شيوخ المعتزلة في ذلك العصر ، وهو أبو على الجُبَّائي « 235 – 303هـ »، فكان من الطبيعي أن يتشرّب الفتى مذهب المعتزلة بحكم البيئة والتربية الجديدة، ولم يزل على هذا المذهب حتى بلغ الأربعين وصار من أئمة الاعتزال والمؤلفين فيه، وأتقن طريقة المعتزلة ومنهج الكلام بالإجمال في المناظرة والجدل والاستدلال.
غير أن أبا الحسن تعرض لانقلاب في حياته الروحية على النحو الذي يقع نادراً في حياة أفذاذ المفكرين ذوى المزاج الحاد الرقيق؛ فانقطع عن الناس حيناً خلا فيه إلى نفسه من تشويش الأدلة الجدلية الكلامية ، واستمع إلى صوت روحه العميقة، ثم خرج إلى المسجد الجامع بالبصرة يوم جمعة وأعلن انخلاعه عن كل ما كان يعتقده من مذهب المعتزلة، ثم دفع للناس كتبا ألفها أثناء غيبته، نصر فيها مذهب السلف المتمسكين بظاهر نصوص القرآن والحديث، وأبرزها مؤيّدة بما كان قد أحكمه من المناهج الجدلية الكلامية. ثم ألف بعد ذلك مالا يحصى من المصنفات في الرد على المخالفين على تنوع مذاهبهم وفي اللب عن الدين .
واختلف الناس في أبي الحسن، بين خصوم من إخوانه السابقين في المذهب يتلمسون لانقلابه أسباباً دنيوية يعارضها ما عرف عنه من الزهد والتقلُّل من الدنيا والتبلُّغ بيسيرها، وأنصار يرون رجوعه هدى من الله أراده إعزازاً لدينه ونصراً له، وبين متشددين ضيقةٌ صدورُهم عن فهم الانقلابات الروحية، طعنوا في قيمة رجعته مضيِّقين رحمة الله. أما الذي يُروى عن أبي الحسن نفسه فهو أنه تحير في الأدلة الكلامية لتساويها ونكافئها في نظره ، فرأى النبي يرشده إلى الرجوع إلى السنة ونصرتها ، فأقبل يتأملها وينشئ الأدلة الجدلية على صحتها ، وغير بعيد أن يكون ذلك عاملاً نفسياً له شأنه الخاص إذا عرفنا ما كان يدور بين أبي الحسن وبين أساتذة الجبائي من مناظرات يذكرها المؤرخون على اختلافهم وقد تَبَيّن للأشعري فيها تناقض أصول المعتزلة وعدمُ كفايتها وقلةُ إرضائها للعقل الناضج من جهة ، وقلة تثبيتها لليقين القلبي في روح المؤمن من جهة أخرى .
وكان المعتزلة في ذلك العصر رغم ما أصابهم أيام المتوكل لا يزالون محتفظين بمركزهم متعززين بما كانوا متربعين عليه من مناصب الرياسة ، مترفعين عن النزول للخصوم ؛ وكانوا قد تطرقوا في أصولهم حتى فلسفوها واصطدموا بالدين الموحي نفسه ، وكادوا يقررون شريعة عقلية فلسفية تقابل الشريعة النبوية وتحدّ منها حتى تجعلها مقصورة على وضع الطاعات ذات المقادير والمواقيت ، مما لا يتوصل إليه العقل ، لأنه ليس من الأمور البديهية . وقد اعتمدوا على العقل في كل آرائهم تقريباً وساروا في بناء تفاصيل مذهبهم من أصول هي أشبه أن تكون أصولاً فلسفية واضحة . فالعقل عندهم مصدر الواجبات الدينية حتى يتوصل إلى معرفة الله ، كما يوجب عليه بعد ذلك سكره ؛ ويعتبر المعتزلة هذا طاعة الله حتى قبل مجيء الوحي . والعقل هو أيضاً مصدر معرفة الخير والشر ، وهو يوجب على الإنسان أن يفعل الخير وتنكب عن الشر ، وهذان وصفان ذاتيان لما يوصف بهما بقطع النظر عن الأمر أو النهي الإلهيين . ولما كانت نقطة بداية تفكيرهم في الإنسان هي أنه حر قادر مختار وبالتالي مسئول عن عمله ، تحتم عندهم أن يكون الثواب والعقاب على حسب العمل ، وعدل الله يقتضي مراعاة ذلك بحيث لابد أن يخلد مرتكب الكبيرة في النار ، إن لم يتب ، والله في رأى المعتزلة قد وضع القوانين وأخبر بتنفيذها ، فلابد أن يراعى ذلك ، كما أنه لم يؤخر عن الخلق شيئاً فيه صلاحهم أو اللطف بهم إلا فعله ، وكل أفعاله معللة بالحكمة التي قتضيها العقل ؛ هذا إلى جانب إنكار المعتزلة للصفات الإلهية حتى أوشكوا أن يجردوا الألوهية من محتواها الديني ، ويتصوروا الذات الإلهية فكرة مجردة كما عند الفلاسفة ، وإلى جانب إنكارهم رؤية الله وما ينتظره المؤمن من لذة مشاهدته ، وجحدهم الشفاعة والغفران الإلهي دون قيد ولا شرط ، ونبذهم الكثير من الأمور الأخروية حتى تلاشت معالم الحياة الثانية المنتظرة بحسب مذهبم ، ووقف المؤمن كأنه في فراغ لا حدود له . وهكذا ساروا في تفكيرهم حتى صار الدين عندهم أشبه بمذهب فلسفي أو دين عقل طبيعي ، وحتى ثار في نفوس الأتقياء هذا السؤال : هل بقى بعد ذلك للدين المنزل مبرّر أو حاجة ؟
وقف أبو الحسن متفكراً في مذهب هؤلاء القوم الذين بعطون للعقل الإنساني ما يجب أن يُعطى لله ، ويخرجون الإنسان ، وهو مخلوق لله ، عن مشيئة خالقة ، ويقنطون الناس من رحمة الله ، وذلك بحكمهم على العصاة بالخلود في النار ، حتى ضيقوا مجال الرحمة الإلهية المبذولة بمحض الجود والكرم ، وينكرون قرب الله للمخلوق كما يحرمونه من لذة مشاهدة خالقه ، ويتأولون النصوص تأويلاً غير يقيني ، حتى تحول الإله عندهم من ذات حية إلى معنى مجرد معطل تقريباً .
كان لابد من رد فعل من جانب الشعور الديني يواجه غلو المعتزلة ، وهو ما قام به أبو الحسن ؛ فهو قد وجد أن روحه المؤمنة لا ترتاح إلى مذهب المعتزلة ، رغم معرفته له على أكمل وجه ، الراحة الحقيقية ؛ كما وجد أنه لا يلتئم مع طبيعة الإنسان بما فيها من ضعف وحاجة إلى الرحمة والمغفرة والفضل ، ومن شوق نحو مصدر الأشياء جميعا ، ومن رغبات عميقة في القلب الآدمي لا يملؤها إلا حب الله والقرب منه .
إن مذهب المعتزلة مذهبٌ مفلسف لا يلائم شعور الإنسان العميق بافتقاره إلى سند من خالقه ، كما أنه لا يحقق الانسجام بين الخالق والمخلوق وبين المشيئة الإلهية المطلقة والمشيئة الإنسانية المحدودة ؛ فنهضت همةُ الأشعري إلى تقرير مذهب مذهب وسط يحفظ الدين حيّا في أعماق القلب ويستعمل العقل مجرد أداة لإثبات صحة النصوص الشرعية وبيان استقامتها على مجرى العقل ، وخصوصا أراد تأكيد حقوق إله القلب وإله الإنسان الواقعي الذي يحب ويرجو ويخاف ويشتاق . وتنم كتب أبي الحسن ، خصوصاً في بيانه لعقيدة أهل السنة ، عن روح التقوى العميقة التي تميل إلى إفناء الإرادة الإنسانية في الإرادة الإلهية ، وإلى وضع الإنسان في مكانه الطبيعي بالنسبة لله ، بحيث يدخل في كنفه ويسند كل شيء إليه ، وبحيث يرضى بحكمه ويلجئ أموره كلها إليه ، وهذا في رأي أبي الحسن هو التوحيد الحق الذي يقرر حقوق الله ولا يعطى الإنسان أكثر مما له .
فمذهب الأشعري ، في مقابل غلو المعتزلة ، هو رجعة عنيفة إلى التقوى العميقة التي لم تَنْمَح آثارها من نفسه في منبته السني الأول ؛ وذلك بعد أن صارت الأدلة الكلامية الجدلية التي خلبت لبّه وخطفت بصره وهو شاب ، غير كافية لإقناع قلبه في الاتزان العقلي والنضج . وإذا كان تصور المعتزلة للدين ولأمور الربوبية يرضى حاجة العقل النظري فإن مذهب أبي الحسن يرضى الروح المؤمنة ويلبي حاجة القلب إلى الإيمان الذي يضع الإنسان تحت لواء الخالق ويغمره بفضله ورحمته ويفتح له إمكان القرب السعيد منه .
ومهما قيل في أبي الحسن وفي مذهبه ، ومهما كان ما أدى إليه حسد خصومه وكيدهم له ولتلاميذه من فتن واضطهاد ، فحسبه أنه قد خرج من تلاميذه كبار العلماء الذين واصلوا بناء مذهبه شامخاً يفخر به تاريخ الدين ، وأنه شمل غالبية علماء المذاهب ، ولا يزال جمهور المسلمين يعيشون عليه حتى اليوم .
وهكذا لم يحرم تاريخ الحياة الدينية في الإسلام من شخص يبارى من سائر الأديان التي يَجْنَحُ بعض منكريها إلى التصور الفلسفي من مفكرين يرجعون إلى الروح والقلب ليؤسسوا الإيمان عليها ، ويكونون بتوسلهم واعتدالهم رمز التفاهم والتسامح الذي يقضي على التعصب للآراء بفضل وضع العقل في داخل حدوده والاعتماد على القلب الحساس .
كان أبو الحسن نبيل النفس واسع الصدر ، لم يفكر أحد من متكلمي الإسلام ، وكان لا يجادل إلاّ مدافعاً ، ويعترف للخصم إذا أقام الحجة ؛ ويُحْكَى أنه عندما حضر أجَلُه استدعى أحد أصحابه وقال له : « أشهد على أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد ، وإنما هذا كله اختلاف العبارات » وهذه هي الروح التي ورثها عنه أجله للماء أهل السنة .