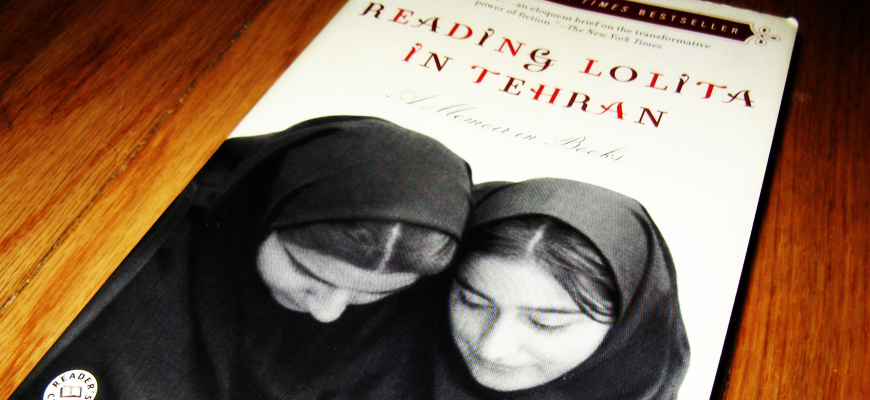
(علم) الجمال
عند ست عجم بنت النفيس بن طُرَز البغدادية (ت. بعد 686هـ )
من خلال كتابها شرح المشاهد القدسية
لابن عربي( ت 638 ﮪ / 1240م )
ست عجم امرأة بغدادية شرحت أحد أصعب كتب ابن عربي ( مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية ) حوالي سنة 686 ﮪ / 1287م ( أي بعد 30 سنة من سقوط بغداد، إِثْر هجوم هولاكو ). وتسوق ست عجم معلوماتٍ عن نفسها تساعدنا على تكوين ترجمة ذاتية لها، (لأنها غير معروفة لا في المؤلفات التاريخية ولا في تراجم الصوفية ). وهذه المعلومات موجودة في كتابها شرح المشاهد ( نُشر في المعهد الفرنسي بدمشق عام2004 ، تحقيق د.بكري علاءالدين و د. سعاد حكيم) وفي رسالة أخرى لها ( تقلد فيها كتاب ابن عربي ) عنوانها كشف الكنوز ، ما تزال مخطوطة. ولها مؤلف ثالث مفقود حتى الآن بعنوان كتاب الختم.
فهي تقول عن نفسها: إنها ” امرأة عامية”، خالية من كل العلوم خلا العلم بالله تعالى الذي لم تصبه بتعلم ولا بقراءة من الكتب ولا من عارف مُوَفَّق، لكنه وهْب من الله تعالى: « أَخْرَجَني من الجهل إلى العلم في ليلة واحدة… وصف تقمص بعد العراء ».
ولكن كيف تمكنتْ وهي أمية من تأليف كتاب صعب أو شرح كتاب مشكل لابن عربي؟ إنها كانت تُمْلِي أفكارهـا على زوجها وهو كذلك ابن خالتها: محمد بن محمد بن الخطيب. وتُبَرِّرُ سهولة هذه المهمـة في التأليف والإملاء على زوجها بالاستناد إلى أصلها: إنها كما تقول : « عربية الأصل ». وتحدد الكيفية التي تتم بها عملية التأليف ثم الكتابة المشتركة مع زوجها قائلة : «عندما يلقي الله تعالى في قلبي شيئاً من العبارة والفيض استنجد به استنجاد مخاللة وأدعوه إلى إثبات ما يرد».
لماذا شرحت ست عجم كتاب ابن عربي؟
تتحدث ست عجم عن « رؤيا » رأت فيها ابن عربي بحضرة جماعة من الأولياء، وذلك بعد موته بنصف قرن !
ـ سألته الاستمداد من « سيرة الولاية » والتوقيف (initiation)على صورة « التسليك »: أي سلوك الطريق الصوفي على يديه.
ـ بالمقابل طلب ابن عربي منها أن تشرح كتابه وأن تفتح استغلاقه، لأنه من « غَوامِض الكتب المُشْكِلَة »، بحسب ” أقواله” .
وتحدد ست عجم بدقة ” علاقتها ” بابن عربي فتقول: « إنه برز في وجودها لمساعدتها على تحقيق الخلافة المختصة بـ ( الإنسان ) الكامل ».
ثم تضيف فـي مكان آخر، حيث تضع نفسـها مـع ابـن عربي في نفـس المسـتوى: ” إننا اختصصنا بالخلافة والمقابلة والمماثلة والاقتسام والاتصاف دون غيرنا من العباد…” ومصطلحات “المقابلة والمماثلة والاقتسام والاتصاف” التي ابتكرتها ست عجم ليس لها مثيل في تاريخ التصوف لا قبلها ولا بعدها . وهي مصطلحات ذوقية ذاتية عبرت من خلالها عن تجربة صوفية – فلسفية فريدة شكلاً ومضموناً. غير أنها تعتبر نفسها، مثلها مثل ابن عربي ، من «أهل الجذب ».
بعض الأفكار عن مذهبها في « وحدة الوجود »:
يتألف الكون بالنسـبة لست عجم ( تحت تأثير ابن عربي ) من أجزاء مقيَّدة لانهاية لها، يُطْلَق عليها اسم « الكثرة ». في المقابل هنالك عالم واحد مطلق، هو الذات الإلهية، يعبّر عن الوحدة المطلقة. العلاقة بين العالمين تحكمها الأسماء الإلهية اللامتناهية أيضاً. وهي، أي الأسماء الإلهية التي طلبت إقامة العلاقة بين الله والإنسان. « لأن مُرَاد الرَّبّ من خلق العباد ظهور الاسم الإلهي».
على رأس هذه الأسـماء يقوم الاسـم “الله” الذي يطلق عليه ابن عربي ثم سـت عجم : صفة « الاسم الجامع ». فالاسم الجامع يختص ” بإدراك متفرقات الكثرة ” ، كما تقول ست عجم.
وبذلك تكون « الكثرة » أطوار « الواحد »، علماً بأن لكل موجود « خصوصية لا يشرك فيها غيره ». وعلينا أن نشير إلى نقطة مهمة في هذا التصور لوحدة الوجود وهـو أن « اسم الله » يتضمن مجموع الكثرة، ولا تتضمن الكثرة « اسم الله ». أي أن وحدة الوجود تصحّ إذا نُظر إليها من جهة الذات الإلهية والاسم الجامع، أما إذا نظر إليها من جهة العالم، فإن التوازي ينقطع. وبتعبيـر آخـر تعترف لنا ست عجم بأنها سمعت في الله إحدى تجاربها الصوفية يقول لها: « أنـا العالم وليس العالم أنـا ». وبمعنى آخـر فإن الله : « يكمل الأشياء وهي لا تكمله ». علماً بأن « كل موجود صادر عن الله » بحسب تعبيرها.
التجربة الصوفية:
تتم هذه التجربة من منظور ست عجم وعلى طريقة ابن عربي ضمن « المشاهد » التي يراها الصوفي. وفي المشهد تتم الصورة عن طريق الرؤية الباطنة التي تجري في القلب، فالقلب منذ الغزالي هو المرآة التي تنعكس عليها الأنوار الإلهية.
ولكن حتى يصل الصوفي إلى هذا المستوى من “الرؤية” فإن عليه « خلع » أو « إلقاء الجسد الظاهر بغير تألم » كما تقول. وأن يقوم في « الصورة » التي خلقه الله عليها، والتـي تنسـب إلى آدم أبي البشر، بحسب حديث نبوي: { خلق الله آدم على صورته }.
فالعارف أو الصوفي الواصل « في حال الشهود لا يكون في حال الظاهر، بل يخرج عن حكم البشرية ». وأصل اللقاء بين الله والإنسان هو مرآة تتوسـط بين الاثنين، وليسـت المرآة إلا من نور إلهي يفيض عن « الذات »، وهنا يصبح الله مشـهوداً، ولكن الشـاهد أو الصوفي لا يرى صورته في هذه المرآة، وإنما يرى نفسه والله شيئاً واحداً وهذا هو « الاتحاد » الذي يشتمل على « الفناء » عن عالم الكثرة و « البقاء » في عالم الوحدة المطلق.
« والخطاب الجاري بين هاتين الصورتين هو سريان اللطف النوري ». وهنا تغدو صورة العارف « مختصرة من مجموع الوجود… لأن غاية العارف إلى التوحيد، وهو معرفة هذه الذات الحقيقية ». والذي يحقق هذه الغاية من الأنبياء والصوفية يصبح « إنساناً كاملاً ». وبالنسـبة لابن عربي وست عجم فإنهما يُعتبران من ورثة النبي محمد (ص)، والذي يعتبره ابن عربي مـن خلال « الحقيقة المحمدية » واسطة بين الله والعالم. وبالتالي فـإن ابن عربي وست عجم بالذات يرثان « الولاية » التي وصلت إليهما. ويرتقيان إلى مقام الإنسان الكامل. إلا أن الكامل واحد في كل زمان، كلما مات ورثه كامل آخر يحفظ « صورة الله » الموجودة على الدوام.
دور الجمال في فلسفة ست عجم:
يلعب الجمال دور التأليف في عالم الكثرة. « لأن الله تعالى، كما تقول ست عجم، لما أوجب الخلـق متكثـراً متميزاً ظهـر بالجميل، لئلا يقع النفور من البعض عن البعض ». ولكن الجمال المطلق « صفة خافية وهمية، فلا يدركها إلا من اتصف في حال شهوده بهذه الأوصاف ». وفي نهاية التجربة الصوفية أو الشهود ينتقل الصوفي من شهود الله، أو شهود الوحدة إلى شهود الكثرة، وفي هذه النقلة يرى حقيقة الجمال .
والجمال هنا حماية للصوفي من النفور، يساعده على التوافق مع العالم الخارجي. تقول ست عجم: « يتـردد العارف بيـن الوجـود المُتَجَزِّئ ( العالـم الخارجي أو عالـم الكثـرة ) وبين الله، ففي حال تردده إلى الكثرة يكون تنازلاً، وحال رجوعه إلى الله يكون استعلاءً. وفي كلا الحالين يظهر « الجميل ». وفي شرحها لمفهوم « الجلال» عند ابن عربي ترى ست عجم بأن الجلال اسم ظهر الله به لتمكين اسم الجميل. فالجلال… هو « الجمال بزيادة تمكين ».
فالجلال كما تقول في موضع آخر: “هَيْبة وخشوع وتعظيم. أما الجمال فإنه محبة”.
هذه العلاقة بين الجمال والحب نجدها بامتياز في نظرية ابن عربي التي عرضها في كتاب الفتوحات المكية ( الباب 558 الخاص بالأسماء الإلهية). وهو يتعرض لها عند شرحه للاسم “الجميل” بالدرجة الأولى ، وكان عرّج عليها أثناء شرحه للاسم “الوداد”. يفتتح ابن عربي الفصل الخاص بحضرة الجمال ( شرح الاسم الجميل ) بالحديث النبوي الشريف : « إن الله جميل يحب الجمال» ، ويتابع الشيخ الأكبر عرض آرائه قائلاً :
« أوجد الله العالم في غاية الجمال والكمال خلقاً وإبداعاً … وما ثمّ جميل إلا هو، فأحب نفسه، ثم أحب أن يرى نفسه في غيره فخلق العالم على صورة جماله… ثم جعل عزّ وجل في الجمال المطلق الساري في العالم جمالاً عرضياً مقيداً، يفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل.» (ف4/269) . وهكذا فإن الجمال “يستدعي” الحب أينما تجلى، وهذا ما نراه أيضاً في الفصل الخاص بـ ” حضرة الودّ “، يقول ابن عربي: « إن جميع المخلوقين منصات تجلي الحق، ما تجلى لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان…فلذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان مجلى ربه.» (المرجع السابق، ص260)
هذا عن ست عجم وابن عربي، وسوف نرى بأن أتباع ابن عربي لا يخالفونهما الرأي، بل يتابعون نفس الأفكار؛ لنأخذ مثلاً: عفيف الدين التلمساني الذي كان معاصراً لست عجم، ومقيماً في دمشق. وقد ألَّف في نفس الفترة تقريباً شرحاً لكتاب النِفَّري ( من القرن 4 ﮪ / 10م ) المواقف،وهو الكتاب الذي نسج على منواله ابن عربي في تأليفه لكتاب مشاهد الأسرار القدسية الذي شرحته ست عجم فيما بعد. فنجد لدى التلمساني مفهومين يتقاطعان مع أفكار ست عجم. المفهوم الأول ويسميه: ” وَجْهُ الحُسْن ” وهو يطلق على جمال الخالق أو الذات الإلهية الواحدة ؛ جمال الذات هذا ينعكس على عالم الخلق والكثرة ، ويأخذ المفهوم الثاني اسم :« حُسْنُ الوجه »، حيث كل مخلوق ينال نصيبه من هذا الحسن([1]) .
الانفعال بالجمال:
يقول العفيف التلمساني في إحدى قصائده:
« وإذا الحسـن بدا فاســجد له فسجود الشـكر فرض يا أخـي » ([2]).
فبالإضافة إلى دور الجمال الذي تصفه ست عجم بأنه « المُرّاد للتأليف وقطع النفور » بالنسبة للصوفي، فإن بقية الناس تُبْهِرهم « صنعةُ الجمال الغامرة للسماوات والأرض»، ويتحيَّرون من حسن القُبّة السماوية.
الجمال والاسم الإلهي ” الظاهر” :
ألّف ابن عربي كتاب التجليات الإلهية في بداية القرن السابع الهجري , ونقرأ في فصل ” تجلي الكمال” نداء الاسم الظاهر للإنسان بلغة الحب المغرّدة على لسان الجمال:
“اسمع يا حبيبي: أنا العين المقصودة في الكون ! أنا نقطة الدائرة ومحيطها. أنا مُرَكَّبها وبسيطها. أنا الأمر المنزل بين السماء والأرض. ما خلقت لك الإدراكات إلا لتدركني بها، فإذا أدركتني أدركت نفسك… حبيبي كم أناديك فلا تسمع، كم أتراءى لك فلا تبصر. كم أندرج لك في الروائح فلا تشم… أنا ألذّ لك من كل ملذوذ… أنا أحسن لك من كل حسن. أنا الجميل أنا المليح. أعشقني… “.
هذا هو نداء الاسم الظاهر المطلق الكلي، أما في حالاته الجزئية الخاصة فإننا نجد نموذجه في الحب الذي عبر عنه ابن عربي تجاه ملهمة ديوانه الغزلي ترجمان الأشواق: واسمها النظام.
إنه يراها ” طفلة ناعمة ” بارعة الحسن، اجتمع بها في مكة سنة 611 هـ ، وهي في الوقت نفسه تعبير حيّ عن تجلٍ للاسم ” الظاهر “. وفي النص التالي لابن عربي نفهم معنى حبه للجمال مجسداً في وجه النظام. ومعلوم في مذهب ابن عربي أن أجمل مكان للتجلي الإلهي هو وجه المرأة بالذات ، حيث لا ينفصل فيه الإنساني المتجسد بالجمال المثالي عن الإلهي المتعالي: يقول ابن عربي: ” طلعت هذه المُتغزل فيها في عالم الملك والشهادة من ” الاسم الظاهر ” الكبير المتعال، فأعطت في هذا التجلي ما تعطي الشمس في عالم الأركان من الأثر المعنوي والحسي إلى أن انتهت بالسير نصف دائرة العالم، ثم غربت عن الملك والشهادة، وكان غروبها شروقاً في عالم الغيب والملكوت”.
ومن الصوفية من ينفعل بهذا الجمال انفعالاً يوصله إلى لذة غامرة يعجز الوصف عن مجاراتها.
المثال الأخير الذي سنختم به هنا يأتي أيضاً من ابن عربي نفسه ومتابعة تلاميذه من:
مدرسة وحدة الوجود مثل أحمد السرهندي من القرن الحادي عشر الهجري .
وقد تأثر الشيخ الصوفي الهندي ( من البنجاب) أحمد السرهندي من القرن 11 هـ بابن عربي وها هو يعرض على شيخه في الطريقة النقشبندية تجربته في الانفعال بالجمال من خلال تجلي الاسم الظاهر عليه في حالة جزئية خاصة أخرى في المكتوب الأول من كتابه: مكتوبات السرهندي ، حيث يتجسد الجمال في وجده الصوفي إما في ألوان الملابس النسائية الباهرة أو في”ألوان” الأطعمة المختلفات المذاق:
” قد تشرفت في أثناء الطريق بتجلي “الاسم الظاهر” تجلياً كلياً بحيث ظهر لي في جميع الأشياء بتجلٍ خاص على حدة، وعلى الخصوص في كسوة النساء بل في أجزائهن على حدة. فصرت منقاداً لتلك الطائفة على وجه لا أقدر على عرضه. وكنت مضطراً في ذلك الانقياد وهذا الظهور الذي حصل في هذا المجال لم يكن في مجال آخر. وما رأيت من خصوصيات اللطائف ومحسنات العجائب في هذا اللباس لم يظهر في مظهر ما أصلاً: قد ذبت بالتمام وجريت كالماء بين أيديهن. وكذلك تجلى لي في كل طعام وشراب وكسوة على حدة على حدة. وما كان من اللطافة والحسن في الطعام اللذيذ المتكلف فيه لم يكن في غيره. وكان ذلك التفاوت بين الماء العذب والملح؛ بل كان في كل شيء حلو شيء من خصوصيات الكمال على تفاوت الدرجات على حدة على حدة. ولا يمكن عرض خصوصيات هذا التجلي بالتحرير فإن كنت في الملازمة العلية لعرضتها”.
([1]) ر. عفيف الدين التلمساني ( ت 690 ﮪ / 1291 م )، دراسة وتحقيق الدكتور جمال المرزوقي، القاهرة سنة 2000م، ص 28.



